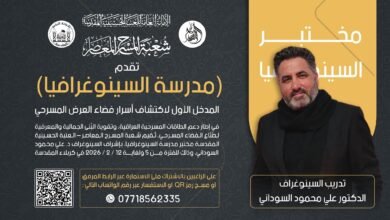نقد الذات المسرحية…استراتيجيات التجريب في تجربة «مسرح كيف»/ آمنة الربيع

نقد الذات المسرحية…استراتيجيات التجريب في تجربة «مسرح كيف»
إنّ المشروع الإبداعي للباحث المسرحي يتجلى من خلال أسلوب اللغة التي يكتب بها، أو اختياره لإخراج عروض مسرحية تتصل اتصالا مباشرا مع موقفه الفكري الثقافي ووجهة النظر إلى العالم والنصّ والمجتمع. وأن اتضاح وجهة النظر، لا تعني الموقف الأيديولوجي المتصلّب، بل تشير إلى قدرة المبدع على انفتاح عقله وتفكيره ومبادئه مع مشروعه الإبداعي على تجارب الآخرين، ويتطلّب هذا بالضرورة قدرة خالصة على نقد الذات لا الغرور. والطموح إلى مفهوم العالمية بمعاني الاعتراف والانتشار والتأثير في سياق الفكر، والأدب، والإبداع، طموحٌ مشروع؛ فلكل مبدع الحق في ذلك، شريطة أن يمتلك ما يؤهله لتحقيقه.
في هذا السياق، إن معنى خروج التجربة الإبداعية من المحليّة ووجودها في العالم، لا تعني وحدها وجود الكتابة الجيدة، ولا الإخراج المحترف، بل تشير إلى إمكانية المبدع في أن يطرح أسئلة كونية، ويشتبك مع الأفكار والرموز الغائرة في الثقافات الإنسانية جميعها؛ لابتكار أشكال فنية جديدة تكون بصمته الإبداعية.
في العالم الغربي والأوروبي، هناك العديد من المخرجين والمؤلفين المسرحيين الذين تجاوزت أعمالهم حدود بلدانهم ليصبحوا رموزًا عالمية أثّرت في تطوّر المسرح على مستوى الفكر والشكل. وفي سياق التجارب العالمية لدينا ما يفتح الباب للتفكير إزاء تفاعل بعض المبدعين العرب (تنويرا ثقافيا ونقديا، وتأليفا وإخراجا مسرحيا) تفاعلت تجاربهم مع المسرح لا بوصفه مجرد فن أدائي وجمالي، بل كأداة للتحليل الاجتماعي، والتفكيك الرمزي، واستنطاق الأسئلة الوجودية الكبرى في الثقافة والسياسة والتاريخ، مثل سعد الله ونوس، لينين الرملي، الطيب الصديقي وغيرهم.
وخليجيا شُغل بعض المسرحيين المبدعين بالتفكير في إنتاج مسرح مفارق لبيئته؛ بالمعنى المغاير للنمط والتقليد، منهم من امتلك مشروعه التنويري، ومنهم من نقش تجربة متميزة في الإخراج أو التأليف، يمكن الإشارة إلى كل من إبراهيم غلوم، صقر الرشود، إسماعيل عبدالله، محمد العامري، وعبدالله السعداوي، الذي انطلق ببصيرة رؤيوية من المحليِّ إلى العربيِّ باحثا في لغة جسدية وبصرية وثقافة صوفية وأسلوب حياة مختلفة، عن صوت خليجي تجريبي لمسرح يعبّر عن القلق والأفكار، متجاوزا التقليد الأعمى للغرب، أو الانقياد للسلطات الثقافية الرسمية. وسليمان البسام، الذي اختط لأسلوبه المسرحي، اشتغالا تجريبيا مفارقا للبيئة المحلية الخليجية والعربية. ففي أعماله المسرحية (ملحمة هاملت العربية، أو ريتشارد الثالث) يصوغ البسام صياغة حوارية ناقدة مع النصوص الكلاسيكية عبر رؤية عربية، سياسية وتجريبية، جعلت من تجاربه مختبرا لتفكيك المسرح العربي من الداخل، وطرح أسئلة حول السلطة والهوية واللغة على الخشبة.
في تجربة قريبة نابعة من السؤال المحلي في المملكة العربية السعودية تتقاطع تجربة «مسرح كيف» للكاتب والباحث المسرحي السعودي ياسر مدخلي مع تجارب الباحثين السابقين. سعى مدخلي في كتابه الصادرة طبعته الأولى عام 2021م البالغ عدد صفحاته (157) صفحة إلى توثيق تجربته الشخصيّة عبر «تقنين الفوضى التي خلقها التجريب وإيقاف مهازل الابتذال» في المسرح. فالكتاب ليس دراسة نقدية، أو مقالات، وليس تحليلا لعروض بقدر ما هو رؤية تنظيرية قائمة على تصور لتقديم تجربة عرض مسرحي ما، وطرح عدة فرضيات حولها، وتلمس نتائجها في أرض الواقع عن طريق وضع (خطة التجربة، وأسئلتها، وآلية تنفيذها، وأهدافها، واختيار مكونات النص، والممثلين ومكان العرض، ثم طريقة الرصد: إن التجربة لا تكون مكتملة إلا إذا رصد المسرحي الباحث اتجاهات وردود الفعل باستبانة يجيب عنها الجمهور»، ودراسة نتائج الاستبانة وتحليلها واستخراج الاستنتاجات).
يدعو ياسر مدخلي في فهرست الكتاب، إلى مسرح صادق وفاعل في مجتمعه، لا يتنازل للجمهور السطحي، ولا يلهث خلف التهريج، بل يقدّم تجربة جمالية وفكرية ترتقي بالوعي، وتحتفي بالتجريب المستمر. يرى أيضا أن المسرح ليس ترفًا، بل ضرورة، وهو أداة تطهير وتحرير، ومساحة أرحب من الواقع ذاته، كما يشدد على أهمية أن يكون الجمهور شريكًا في العرض، وعلى ضرورة أن يُكتب النص ليُرى، لا ليُقرأ فقط، فالعالم يصنع المعاناة، والمسرح يحوّلها إلى متعة معرفية.
أكد سعد الله ونوس أن إدراك الحاجات الأساسية للجمهور يشكل نقطة التحوّل في تطور المسرح العربي. وينطلق مدخلي من هذه الفكرة ليولي اهتمامًا خاصًّا بطبيعة الجمهور؛ «هذا الجيش الذي يصطف أمام تجربتك إما أن يكون معك، أو يحارب ضدك؛ لذلك يجب أن تفهمهُ وتَدرسه جيدا وتتوقعه»، فيطرح في فقرة بعنوان «كيف تصمِّم تجربة مسرحية؟» تساؤلات جوهرية حول طاقة التلقي لدى الجمهور، فيسأل: «هل سيتقبّل الجمهور أن أطرح أكثر من 20 أو 40 أو حتى 60 قضية في عرض واحد؟
فإذا كانت هذه إشكالية لا تزال حاضرة في بعض نصوص وعروض مهرجاناتنا الخليجية، حيث تزدحم بقضايا متعددة تُربك البناء، وتضعف الأثر الدرامي، إلا أن نتائج استبانة مسرحية (خطيرين- 2006م) كما يقول ياسر: إنها كانت مفاجأة؛ «الجمهور […] يطلب إدراج قضايا أخرى».
إذا سألنا المؤلف عن الدافع إلى اتخاذ هذا النهج فيجيب: «إن ما دفعني إلى تصميم نموذج للتجربة المسرحية في (مسرح كيف) هو ذلك الوضع غير المُرضي لي -على الأقل- والذي أصاب المسرح بشكل عام، فأصبح العرض السخيف يتفوّق جماهيرية وتأثيرا على العرض العميق، ويكون الدعم للمهرجين المبتذلين دون المفكرين والأدباء المبدعين». عبّر مدخلي بصدق عن صراع دائم بين المسرح بوصفه فنًّا فكريًّا نقديًّا، والمسرح بوصفه منتجًا ترفيهيًّا استهلاكيًّا. وهي أزمة يعرفها معظم المسرحيين الذين يحملون مشروعًا ثقافيًّا تنويريًّا، في الخليج وفي سائر العالم العربي.
تحت عنوان «تجارب مسرح كيف»، يستعرض مدخلي بشيء من التفصيل تسع تجارب، منها؛ تجربة «التكثيف اللغوي» في الكتابة المسرحية مجسّدا في عرض (عزف اليمام)، وتجربة عرض (أشباح- 2008م)، الذي أخرجه بأسلوب «المسرح الأسود»، والهدف منه «استطلاع جدوى هذا الشكل لدى المتلقي طوال العرض المسرحي»، وأظهرت الاستبانة الموزعة على الجمهور أن هذه النوعية من العروض تحتاج دقة في التدريب واشتغالا على علاقة الممثِّل بالمكان.
الناظر إلى سنة إنتاج عرض أشباح، يُشكِّل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نقلة في حداثة المسرح. إن تأثر المسرحيين الشباب في السعودية ودول خليجية أخرى، بدرجات متفاوتة بعناصر المسرح الأسود له مبرره الموضوعي، حيث يُعدُّ القرن 21 امتدادا للحداثة المجتمعية وتطورها في العالم، فانتشرت العروض المسرحية التجريبية ذات الخلفية السوداء، والملابس الفسفورية، والإضاءة فوق البنفسجية؛ عروضا غاب عنها الكلام، وأفسح المخرجون المجال لإبراز لغات أخرى كجسد الممثل، والإيماءة والموسيقى. لعلّ الدافع وراء هذا الاستخدام يعود إلى ارتباطه المباشر بعولمة التقنية، وهذا ما يجعل استخدامه أقرب إلى السهل الممتنع، فالفلسفة التي يتجذّر فيها هي عولمة الفراغ، والصمت، والحركة المعزولة للبشر والكون في فضاء مظلم.
من التجارب المهمة في الكتاب، عرض (مجانين) وعنونها: التعويم (إلغاء الزمان والمكان والشخصيات)، وتجربة (مونودراما ظلا) التي انطلقت من مشروع بحث حول الأهمية والأثر للمسرح في المجتمع السعودي، ضمن الدراسات العليا في مسار البحث الاجتماعي. أما (البرمائي) فهي تجربة أصفها بالنوعية حيث تأسست من تباين ردة فعل الجمهور وتفاعله في مسرحيتي مجانين، وأشباح، وسؤالها: هل سيشارك الجمهور لإنقاذ عرض فيه جزء رتيب وإيقاع هابط من عرضين مختلفين!
في ثلاثة عروض هي: (علاجك أمل- 2011م)، و(عميان-2012م)، و(تصرح دفن- 2014م) سأقف عند الأولى لاتصالها بمستوى اشتغال إشكالي في المسرح هو فن المرتجلة. يبحث العرض في السؤال: ما هي معايير الارتجال؟ وما الفرق بينه ومفهوم الخروج عن النَّص؟ بعد النتائج التي توصل إليها مدخلي، كنت أود أن أقرأ في الكتاب نموذجًا موثقًا للمرتجلة؛ ومعرفة كيفية أنجزت المعايير.
من اللافت في هذا الكتاب حضور فكرة «المسرح بوصفه مشروعًا» تتكرر في طيات صفحاته، وتظهر من خلال اهتمام المؤلف بتقصي المفاهيم والعراقيل التي تعترض التجربة المسرحية، سواء من حيث التلقي أو من حيث الإنتاج.
المشروع هنا رؤية ثقافية تنظر إلى المسرح كأداة تغيير ومساءلة اجتماعية وجمالية في آنٍ معًا. يقدم ياسر مدخلي في كتابه «مسرح كيف» أفكارًا جديدة تتعلق بجوهر التفكير بالمسرح، وكتابه يُسهم في تطوير المختبر المسرحي والتوثيق ونقد الذات، وهذه من مواطن القوة في الكتاب؛ لاتصاله بسياق المسرح الخليجي المعاصر.