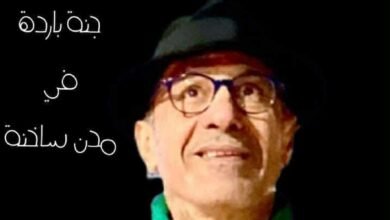مسرحية الصمت واحتمالات طروادة / د.نورس عادل

مسرحية الصمت واحتمالات طروادة
إلى المسرح مرة أخرى “أنا أستعمل الكلمات التي علمتني إياها، فإذا لم تعد تعني شيئاً علمني غيرها أو دعني أصمت” لصمويل بيكيت – نهاية اللعبة. مرة أخرى يضعنا المسرح أمام مقدرته الفارقة في صناعته للأسئلة، وأي اسئلة تلك التي تشحذ سكينها على مقربة من نياط قلب هذا العالم، هذا ما قدمته لنا الفرقة البولندية للمسرح المتنقل (Teatr Biuro Podrozy) في إحدى الأماسي الديناميكية لمهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته السادسة، إذ قدم العرض المسرحي (الصمت) في أحد الفضاءات المفتوحة للعاصمة بغداد وهو عرض مسرحي من تأليف واخراج “باول سزكوتاك”.
مرة تلوى الأخرى نلوذ بأبينا المسرح من نوايا مشعلي الحرائق في أزمنة القحط الإنساني والضمائر الضالة والصمت، الذي حاصر أحلامنا كما حاصر الهشيم ذات حرب بيوت طروادة العامرة، فبالحرب تتحول الأحداق لشواهد مقبرة تشابهت فيها أسماء الموتى “فالحرب تضع أزبالها في العينين” هكذا أخبرنا فلاح شاكر ذات نص فتحت له أبواب الجنة متأخرة، وهكذا تشتعل أرواحنا في مضمار خشبة بافلوفية تهشم اشتراطاتها صبر الحكايات وتذبح مساقطها نشيج القصص الموحشة، فحين يتعاطى عرض بفنون الاداء (الما بعدية) تُقطّع اوصال الوعي بتاريخٍ لطالما كتبه المنتصرون ويعاد فيه الفهم إلى نُطف الحقيقة الأولى، وما يستمر في التمثل المّر لجسد الممثل وبوحه في قتامة انشطاره بين شخوص محقتهم صدف الحرب وآخرين تستحضرهم ذاكرة المتلقي ويغتابهم الفضاء المفتوح بتناص يطرح نص الممثل “لجاك ليكوك” بوصفه انقلاباً على الكتابة الصلبة وانبعاثا لما يفكك أسرار المعنى خارج جهوزيته.
ففي ظل عالمٍ تستبدل فيه الموسيقى بطبول الحرب لن يجد الممثلون فيه نصاً يوازي أجسادهم ليستعيضوا بتلك الأجساد عن صور حياة صار يكتب نصها أمراء الحرب والجنرالات وينفى فيها المؤلفون، فثمة لحظة يمكنها أن تنبعث أكثر وأكثر بهول حدث مستمرٍ، وثمةَ مصطنعات لقيامة (هوميروسيةٍ) قادرة على إدامة عوارض (الميتا أزمنة) بحيث تربك هذه المتشكلات حركيةَ الحدث الدرامي وتعيد تكوين بنيته وقابليته دون المضي أو الزوال عن ذاكرة يفقأُ عينيها الالم الاوديبي ذاته، فليس ثمةَ خطيئةٌ أكبر من موت صبية لم يبلغوا بعد عشاءهم الاخير، وليس ثمة مقاربة أقسى من الجسد الميت الذي تشيرنا إليه دمى العرض وهي ترقب بصمت مطبق صمت المتفرج.
ففي عوالم كثيرة الشبه بعوالمِ “موريس ميترلنك” يشكل العمى نصف الحقيقة، ويشكل الحس نصف الفرادة ونصف البوحِ أيضاً، وفي ظل عوالم يقبحها الصراخ والضجيج يراهن المعنى على مرارة الصورة، على مسرحٍ لا يدع للحياد مكاناً فيه، فلا خيار مع المسرحِ كما هو الحال مع الحقيقة، فإمّا أن تظل صامتاً على الرغمِ من كل ما قد يُحدث كلامك من ضجيجٍ، أو أن تسترق قبساً من لغات آلهة غابرة تعلمك كيف توصل صمتك إلى الجانب الآخر من العالم..هكذا إذن وبمروية كبرى يلامس المؤدي فيها مضامين القداسة (الغروتسكية) تفتتح الحكاية على نص يسك مسائلاته بطقوس الاختزال لنص الجسد، الذي طالما بحث عن لقائه الأثير بالجمهور عبر العديد من نظريات الممثل المؤدي وعبر افتراض يحرر بمصنعاته فضاء تشاركي يُبنى على اللعب، وعبر تكوينٍ بصريٍ ممهورٍ بمسرحِ السرد التشكيلي يؤثثُ ذلك الفضاء/ العرض ارتباطاً وثيقاً بتعاليم “كانتور وشاينا” في صناعتهم للمشهد الحي، وفي اشتغال لطالما ارتكز على ثنائية (المكان/ الذاكرة) وعلى التعبير بالنص البصري عن ملفوظات نص المؤلف، فسينوغرافيا هذ النوع المسرحي تنبت ما بين ظفر الممثل/ المؤدي وبين رؤى المخرج السارد وتعشش في تقاسيم وجه وخطوط جبهت العرض التي تقطع على المتلقي طريق العودة وتكسر افقاً يمتد نحو خيبات تتجذر في يومياتنا عبر نشرات الأخبار وصور “الفيسبوك” لمن لم يشهدها في حياته العابرة.فبالحديد والنار يُنتج الخطاب الجمالي للعرض فضاء مفتوحاً على الشعائر المعاصرة للمذابحِ وهي تجتاز حدود الخشبة التقليدية، ويباعد صدع الصدفين مرة أخرى وتذيب رؤى العرض زُبر الحديد على عوالم تتغول فيها القسوة وتتحول فيه أماني النجاة من حصار حرب واحدة إلى تورط العمر بحروب وحصارات قد لا تنتهي، وبالنار والحديد أيضاً يدعونا العرض المسرحي الموسوم بـ (الصمت) أن نراجع عطايا آلهة لم تراودها كوابيس ما آلت إليه نوايا البشر، من بشاعة تفوق رهانات الجحيمِ وصوره المحفوظة في خزانات جبل (الاولمب) كآخر تذكارات الإله (هاديس) عن عوالمِ موتاه.. بالنار والحديد تَسلخ الاسئلة جلدها متبرئةً من كل هذا الصمت الذي لم يزل في المسرحِ فقط يمثل تصريحاً مباغتاً لألمِ التجربة، فلا ضير في مسرحٍ يجعلنا نحس قبل أن يدفعنا كي نفهم، ولا ضير في أن تدب الحياة بفعل لم يزل يتشكل عند حدود المعنى، ولا ضير في معنى يضعُنا داخل حدث لم يزل قائماً، لا امامَ حدثٍ تنعشهُ غرفُ العنايةِ المركزة لنقاد ما بعد التأويل، يُطالعنا عرض (الصمت) برهانات التأثير للممثل المؤدي عبر مصفوفة طقسية تشكلها الأجساد/ الدمى لا الأفواه، وتُنتج سرديتها عبر متوالية صورية قائمة على تشكيل الدوال بفواعل ديناميكية تقضم المسافات ما بين صور العرض ووعي الجمهور، كما لو أنها لوحةٌ وحوشيةٌ قد اصابت ما تبقى من بياض خارج اللون بذعر الاحتمال القادم. فالصدامات الحسية التي تفرزها النظم العلامية لمشاهد العرض، من دماء واقتتال وعمالقة لم تمثل سوى مفتتحٍ لتغولِ واقع مريرٍ ووثيقة بصرية يتمسرح فيها الحدوث المستمر لقساوة اعتيادنا النظر إلى ما يحدث حولنا من خراب، يخبرنا العرض عن لوثة الاعتياد، عن تواطؤنا مع ما يستدرج خطانا نحو خراب الإنسان القادم، كما يخبرنا أيضاً بأن الصمت لم يكن ليمثل غياباً للصوت بقدر ما هو انبعاثٌ أخير لعجز الضحايا في التعبير عن صدمتهم بإزاء صمت العالمِ من حولهم.
فحين يرتكز المسرح إلى جسد الممثل فأنه يفتش في ما يقرب من ثلاثة آلاف عامٍ من التجربة، باحثاً عن لغة ربما تكون قادرة على عبور ممرات الاحتيالِ والتهرب من سلطة الرتابةِ قبل التهرب من سلطة المنع والرقيب أيضاً، ففي اللغة الأمِ هذه تمتثل ذات الممثل لذواتنا فتعبر نحو معراجها وتنقل المعنى إلى فضاء حسي يماحك هزائم من قطعت أجسادهم عرض الصمت وتقطعت بهم الأحلام عند وحل الحقيقة، أملاً في أن تضعنا هذه اللغة جميعاً أمام سؤال (حافلةِ الجحيمِ ذاتها) تلك التي قد تمر بأوطاننا ذات حرب دونما نذير، أن يقرأ المسرح نشيده بلغة صامتة ذلك يعني أن فجيعة الحدث قد اجتازت مقادير الكلام المنطوقِ على مذبح التعبير، فرهانات التأثير هي الرهانات الحاضرة والمنشودة عند عتبات الفهم ابداً، وهول القيامة كمشهد لعوالم جحيمية هي التي افقدت العرض قدرته على النطقِ واللفظ. ولعل من استدل على الممشى السردي في بنى مرويات العرض وخطابه يفهم لما استدار الحدث مراراً حول مشاهد بعينها بتكرارات اخرجت الخطاب عن عرف البناء الدرامي باعتماده الصدام المرتد وتشاركية المسافة واستباحة بالفعل الادائي لحدود التلقي وما تنتجه من انفعال، ولعلنا في نشيد هذا العرض نخرج أيضاً عن مرثيتنا الجنائزية ونختار ألا يدجننا الخذلان ولا تحولنا قواه إلى مادة لحمية قابلة للتدوير، فإن لم يتحرك اللحم الآدمي “لأجل عشرة ملايين روحٍ تسكن هذه المدينة” بحسب لافتة رفعها العرض – فمتى سيتحرك إذاً؟ ذلك هو السؤال الذي سكن رأس هوميروس قبل أن يحز بمدية صنعتها حضارات العسكر وهي الكناية المعلنة في مشهد رفع رأس هوميروس فوق حافلة اللاجئين.
فأي فيوضات بصرية تلك التي تمتلك القدرة على مفاتحة الهول عند لحظة لم تهرب من حدثٍ بعد، إذ قلص خطاب العرض المسافة إلى أقل من جسد ما بين شرق العالمِ وغربه، وفتح الرؤيةَ على مصراعيها في حدقة عين واحدة استطاعت أن تعاين كل ما يحدث من تهجيرٍ قسريٍ تحت سقف الله الواحدة، كل ذلك يحدث في فرجة واحدة متخلية عن مرجعيات الحدث والهوية ومتخلية عن الشعبوية والعرق عن السبب والنتيجة، فرجةٌ لا تنقاد نحو أفق دراميٍ يؤسس لبدايات القضايا ولا احتدام سياسات العالمِ، هكذا بدت فرجة الصمت في عرضها علينا خالصةً في مراجعاتها الإنسانية لما يحدث في (غزة) مثلاً وما يحدث في (أوكرانيا) ربما، بل لما يمكنه أن يحدث لنا نحن العالقين على حافات عالمٍ يوشك على الانهيار، فرجة مخلصة للمسرحِ كخطاب إنسانيٍ محض لا ضير منه إن لم تمرره تعاليم (ارسطو) ولا ضير منه أن تجنب التراجيديا التقليدية، خاصة أن النص يجتاز قسوة الكابوس ويجانب الهجاء الاجتماعيّ الساذج أو إعادة رص اخلاقيات الولولة والنحيب الممهور بما ظنناها يوماً مأساة عابرة في تاريخ درامي ما، ففي محنة الإنسان المعاصر يتفوق الالم على اشتراطات الدراما ووحداتها الثلاث، ويمكن للفكرة أن تفقدَ اتزانها في مكابدة ما يفوق الاحتمال بأقسى كوابيسه المتصورة، فثمة أمكنةٌ لا تستعيد الذاكرة واقعيتها، إذ هي عالقة في فراغِ التعبير عن الألم، وثمة وقائع ضالة لا تُحتسب بها أعمار البشرِ، ولا تفضي فيها المواقيت إلى شيء. وثمة ما يخبرنا في هذا العرض أن “علينا جميعاً أن نستيقظ أو أن نخرج من الصورة”، فالحافلة الحمراء التي تحمل اللاجئين لم تزل تعمل في شتى بقاع الله، ولم تزل تحاول أن تهرّب أعمار الصغار، والعالم هو من تعطل من حولها كما تعطلت قدرةُ المجتمعاتِ الرافضةِ للاجئين على النظر لعزلتهم الأدمية خلف نوافذٍ أغلقتها الاحتمالات المخيفة وغلفتها خطابات العنف الطروادي بسوسيولوجيا العزلة والكراهية ولنتساءل جميعاً عن الذين أوصلونا لهذا الحضيض وأسموه عالماً عن نخاسة الأعمار، التي لم تستثنِ من مناقصاتها الاممية حتى صغار البشر، عن العيون والشواهد التي تخلفها الحروب كل يومٍ، فما الذي تنتظره الذاكرة القادمة.